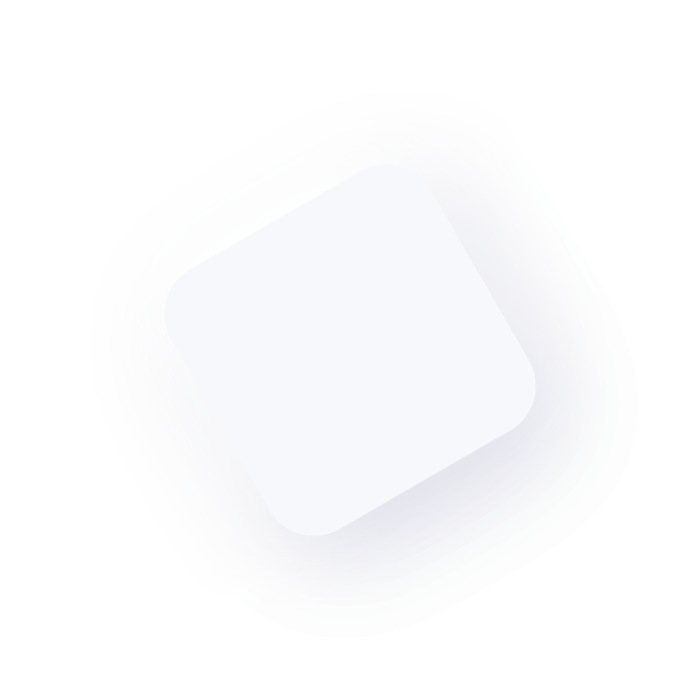أمين الجندي
في أروقة حمص العتيقة، وبين حجارة بيوتها السوداء وقصور أعيانها، تفتحت قريحة شاعرٍ لم يكن كغيره من شعراء عصره، إنه الشيخ أمين بن خالد الجندي، سليل الأسرة العباسية العريقة، والرجل الذي استطاع أن ينتشل القصيدة الشامية من ركاكة عصر الانحطاط ليعيد إليها نضارتها ورقتها وموسيقاها العذبة.
وُلد أمين الجندي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي، وتحديداً عام 1766، في بيئةٍ كانت تموج بالمتغيرات السياسية تحت الحكم العثماني، لكنها كانت تعاني في الوقت ذاته من جمودٍ أدبيٍ طغى فيه التصنع اللفظي على صدق العاطفة. وسط هذا الجو، نشأ الجندي نشأةً علميةً دينيةً رصينة، فحفظ القرآن الكريم ودرس الفقه واللغة، ليتولى لاحقاً منصب الإفتاء في مدينته حمص، جامعاً بذلك بين وقار العمامة الدينية ورقة الروح الشاعرة.
لم يكن أمين الجندي مجرد ناظمٍ للقوافي، بل كان فناناً يمتلك حساً موسيقياً مرهفاً جعله رائداً من رواد "الموشحات" و"القدود"، وهو اللون الغنائي الذي اشتهرت به بلاد الشام وحلب تحديداً. لقد أدرك الجندي بحسه الفطري أن الشعر العربي بحاجةٍ إلى أن يتحرر من القيود الجافة، وأن يعود ليعانق الموسيقى كما كان في عصوره الذهبية في الأندلس، لذا انصرف إلى نظم الموشحات والأدوار الغنائية التي تميزت بسهولة ألفاظها، وعذوبة إيقاعاتها، وقربها من الوجدان الشعبي، دون أن تتنازل عن فصاحتها وجزالتها. كان شعره ينساب كالماء الزلال، خالياً من التعقيد والغموض الذي وسم شعر معاصريه، فكان "السهل الممتنع" الذي يطرب له الخاصة والعامة على حد سواء.
عاش الجندي حياةً حافلةً بالأحداث والتقلبات، فلم يكن منعزلاً في صومعة، بل كان في قلب الأحداث السياسية والاجتماعية في بلاد الشام. تنقل بين حمص ودمشق، واختلط بكبار رجال الدولة والأعيان، وكانت له صلاتٌ وثيقةٌ بحكام الولايات، لكن هذه العلاقات لم تخلُ من التوتر والمكائد، مما عرضه لبعض المحن والنكبات التي صقلت تجربته الشعرية وأضافت إليها بعداً إنسانياً عميقاً. وفي دمشق، التي كانت تموج بحلقات الطرب والأدب، وجد الجندي مسرحاً رحباً لإبداعه، فصار شعره حديث المجالس، وتناقل المغنون قصائده لتصبح جزءاً أصيلاً من التراث الموسيقي الشرقي.
لعل أبرز ما يميز تجربة أمين الجندي هو تلك التوأمة الخالدة بين الكلمة واللحن، فقصائده لم تُكتب لتقرأ في الكتب فحسب، بل كُتبت لتُغنى وتُصدح بها الحناجر في الليالي المقمرة. ومن منا لا يعرف قصيدته الشهيرة "يا غزالي كيف عني أبعدوك" أو موشحاته التي لا تزال تُغنى في حلقات الطرب الحلبي والشامي حتى يومنا هذا، لقد استطاع هذا الشاعر أن يخلد عاطفة الحب العذري والوجد الصوفي في قالبٍ فنيٍ بديع، مازجاً بين لغة الفقيه الرصينة وعاطفة العاشق الوله، لتخرج قصائده لوحاتٍ فنيةً نابضةً بالحياة.
يُعد أمين الجندي حلقة وصلٍ هامةً جداً في تاريخ الأدب العربي الحديث، فهو يمثل الجسر الذي عبرت عليه القصيدة العربية من جمود العصور المتأخرة إلى رحابة عصر النهضة. لم يكن شعره تقليداً أعمى للقدماء، ولا ثورةً حداثيةً كاملة، بل كان تجديداً واعياً يستلهم روح التراث الأندلسي والشامي، ويعيد صياغتها بلغةٍ عصريةٍ تناسب ذوق عصره. لقد مهد الطريق لشعراء كبار جاؤوا بعده، وأثبت أن اللغة العربية قادرةٌ على التجدد والمرونة، وأن الشعر الحقيقي هو الذي يلامس أوتار القلوب قبل أن يقرع أبواب العقول.
توفي الشيخ أمين الجندي حوالي عام 1841، تاركاً خلفه ديواناً شعرياً يزخر بالدرر، وإرثاً موسيقياً لا يزال حياً في ذاكرة الأمة. لم يمت الجندي بموته، فكلما صدح مغنٍ بقدٍ من القدود الحلبية، أو ترنم بموشحٍ من موشحاته، حضرت روح الشيخ الجندي، الفتى الحمصي الذي جعل من الكلمات ألحاناً، ومن الآلام طرباً، ومن الشعر حياةً خالدة. إن سيرته ليست مجرد سيرة شاعرٍ مر في التاريخ، بل هي قصة عشقٍ أبديةٍ بين الشام وشعرها، وبين الموسيقى والكلمة، خطها قلم شاعرٍ كان يغمس ريشته في مداد القلب ونور الروح.