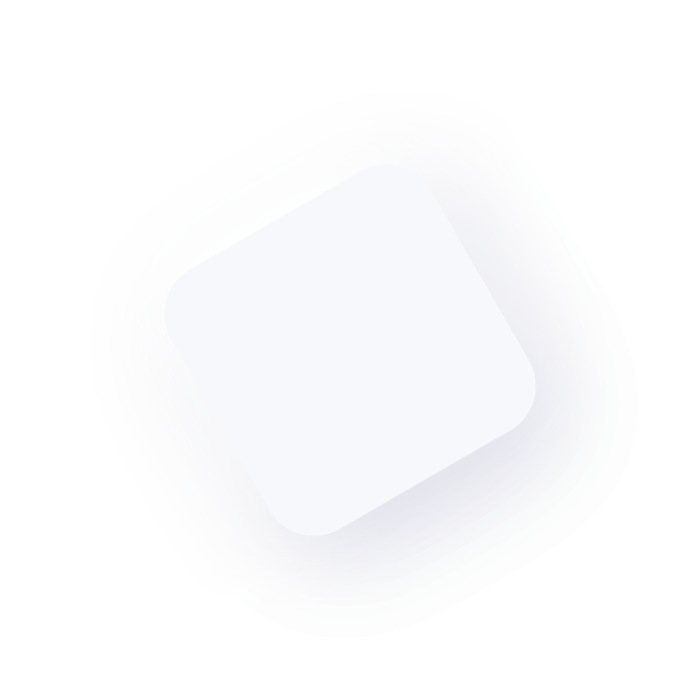ديك الجن الحمصي
على ضفاف نهر العاصي في مدينة حمص، وبين بساتينها الغناء التي كانت تضج بالحياة واللهو، عاش شاعرٌ غريب الأطوار، متفرد النزعة، لم يشبه أحداً من شعراء عصره، ولم يشبهه أحد. إنه عبد السلام بن رغبان، الذي عرفته العرب بلقب "ديك الجن"، ولعل في هذا اللقب الغريب ما يشي بالكثير عن شخصيته القلقة والمتمردة، فقد قيل إنه لُقب بذلك لعيونٍ خضرٍ كانت له، وقيل لولعه بالبساتين واختبائه فيها، وقيل لقبحٍ في خلقته تلازم مع فصاحةٍ ساحرةٍ كأنها سحر الجن. كان ديك الجن ظاهرةً استثنائيةً في العصر العباسي، إذ خالف العرف السائد للشعراء آنذاك، فرفض أن يغادر مدينته حمص، وأبى أن يقف بباب خليفةٍ أو يستجدي أميراً بشعره، مفضلاً أن يعيش حراً طليقاً، ينظم الشعر لنفسه وللذته ولأحزانه، لا للدنانير والدراهم، مما جعله "شاعر الوجدان" بامتياز، بعيداً عن تكسب المديح ونفاق البلاط.
كانت حياة ديك الجن في بدايتها سلسلةً من مجالس الأنس والطرب، فقد كان مغرماً بملذات الحياة، عاباً من كؤوسها، ومشتهراً بشعر "الخمريات" الذي برع فيه براعةً فائقة، لكن هذا الوجه العابث للشاعر لم يكن سوى قناعٍ يخفي وراءه روحاً شديدة الحساسية، وقلباً يفيض بالعواطف المتأججة التي ستقوده لاحقاً إلى واحدةٍ من أفظع المآسي العاطفية في تاريخ الأدب العربي. لم تكن مأساته في فقدان مالٍ أو جاه، بل كانت في الحب، ذلك الحب القاتل الذي حول حياته من نعيمٍ مقيمٍ إلى جحيمٍ لا يطاق، وجعل منه النسخة العربية المبكرة والأكثر دمويةً لشخصية "عطيل" شكسبير.
عشق ديك الجن جاريةً نصرانيةً من أهل حمص تدعى "ورد"، وتيم بها هياماً ملك عليه أقطار نفسه، حتى أعتقها وتزوجها، وعاش معها أياماً كانت كالحلم الجميل، يتبادلان فيها كؤوس الهوى والشعر. لكن الرياح أتت بما لا تشتهي سفن العاشق، فقد كان لديك الجن ابن عمٍ يدعى "بكراً"، كان يحسده على مكانته وعلى حب ورد له، فأضمر له شراً وسعى للتفريق بينهما. استغل بكرٌ سفر ديك الجن وغيابه عن حمص، لينسج خيوط مؤامرةٍ دنيئة، فلما عاد الشاعر، أوهمه ابن عمه بأن زوجته ورد قد خانته في غيابه، واختلق أدلةً وشواهد كاذبةً أشعلت نار الغيرة العمياء في قلب الشاعر الموله.
في لحظة طيشٍ وجنون، وسورة غضبٍ عارمةٍ غيبت عقله، استل ديك الجن سيفه وانقض على حبيبته ورد فقتلها، ظناً منه أنه يغسل عاره وينتصر لكرامته، ولم يكتفِ بذلك، بل تقول الروايات المأساوية إنه أحرق جثتها وصنع من رمادها كأساً ليشرب فيه الخمر، ليمتزج بها للأبد في طقسٍ جنائزيٍ مرعب. لكن الحقيقة لم تلبث أن تكشفت، وظهرت براءة ورد كالشمس، وعرف ديك الجن أنه قتل أطهر الناس وأحبهم إلى قلبه ظلماً وعدواناً، فتحول سيفه إلى ابن عمه بكر فقتله، ثم انهار عالمه بالكامل، وسقط في دوامةٍ من الندم والجنون لم يخرج منها حتى وفاته.
تحول شعر ديك الجن بعد هذه الفاجعة من وصف الخمر والملذات إلى "المراثي" المفجعة، وصار شعره بكاءً متصلاً ونحيراً لا ينقطع، يرثي فيه قتيلته التي قتلها بيده، ويعذب نفسه بجلد الذات. نقرأ في قصائده صرخات معذبٍ يتمنى الموت ولا يجده، ويناجي طيف حبيبته في كل زاويةٍ من زوايا حمص. ومن أشهر ما قاله في رثائها قصيدته التي يقطر منها الدم والدمع "يا طلعةً طلع الحمام عليها... وجنى لها ثمر الردى بيدي"، معترفاً بجرمه، ومؤكداً أن سيفه الذي قتلها إنما قتل قلبه هو قبل أن يمس جسدها. لقد أضفى هذا الصدق الفاجع على شعره خلوداً وتأثيراً لا يمحى، وجعل قصائده وثيقةً إنسانيةً عن الغيرة والندم، وعن الهشاشة البشرية أمام عواصف العاطفة.
يتميز أسلوب ديك الجن بقوة العاطفة وسلاسة اللغة، والبعد عن التكلف والتعقيد اللفظي الذي شاع في عصره، وهو ما لفت انتباه كبار الشعراء إليه، فقد زاره "أبو تمام" في حمص، وأعجب بشعره أيما إعجاب، حتى قيل إن أبا تمام استفاد من مدرسة ديك الجن في توليد المعاني والصور، لكن الفارق أن ديك الجن كان يكتب بدمه، بينما كان غيره يكتب بمداده. كان شعره مرآةً صافيةً لروحه المعذبة، وتجسيداً حياً لمقولة أن "أعذب الشعر أكذبه" إلا في حالة ديك الجن، فقد كان أعذب شعره أصدقه وأكثر إيلاماً.
عاش ديك الجن ما تبقى من حياته في عزلةٍ وكآبة، طيف ورد يلاحقه، وكأس الرماد في يده، وشعره يتردد صدىً لأحزانه في أرجاء حمص، حتى وافته المنية عام 235 هجرياً، وقيل 236. رحل الشاعر القاتل والقتيل، الجلاد والضحية، تاركاً خلفه سيرةً تراجيديةً وشعراً ينبض بالحياة والألم، ليظل اسمه محفوراً في ذاكرة الأدب العربي كرمزٍ للحب الذي يقتل صاحبه، وللندم الذي لا يكفره سوى الموت، وللعبقرية التي تولد من رحم المعاناة والجنون.